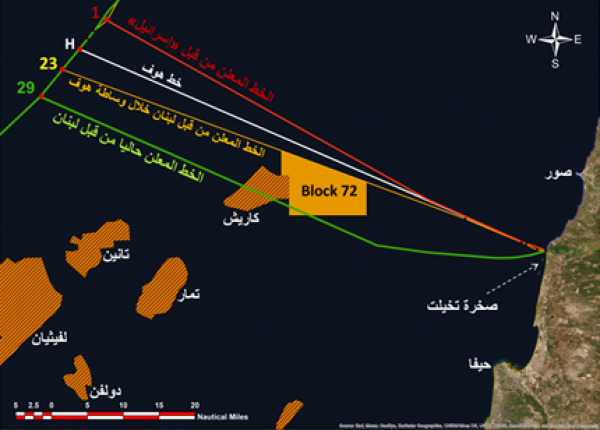13 نيسان وأسباب الحرب الأهلية
فرز اللبنانيين الطائفي والمذهبي الذي يقوم عليه هذا النظام، أتاح ويتيح لزعامات وأحزاب الطوائف والمذاهب، تسعير الشحن الطائفي، وزرع الخوف لدى جمهور كل طائفة من الطائفة الاخرى، وربط ذلك بالخوف على الكيان الوطني نفسه، ممّا يُبقي على هشاشة الاستقرار والوحدة الداخلية، ويجعل الوضع مهيّئاً للتوترات والتصدّعات والحروب الأهليّة، المُسلّحة أحياناً، وغير المُسلّحة دائماً.
ففي مواجهة أزمات النظام المتراكمة بوجهيها الاجتماعي والوطني، التي برزت في أواخر ستينيّات القرن الماضي والنصف الأول من سبعينيّاته، وتصاعد التحرّكات الاجتماعية العمالية والشعبية والطلابية، وتحرّكات المزارعين... وترافقها مع انكشاف تخاذل هذا النظام وسلطته، إزاء عدوان اسرائيل على مطار بيروت الدولي وتدمير حوالي 12 طائرة لشركة M.E.Aعام 1968، وتكرار اعتداءات الكوماندوس الصهيوني على القرى الحدودية وأهلها، وصولاً إلى دخول كوماندوس العدو إلى قلب بيروت وقتل ثلاثة قادة فلسطينيّين في منازلهم، عام 1973، دون قيام السلطة بإطلاق أي رصاصة على المعتدين. تصاعد الاستياء الشعبي والمطالبة بتحقيق إصلاح جدّي في المجالين الاجتماعي والوطني. ولكن بدلاً من تبنّي ذلك، لجأت السلطة، دفاعاً عن نظامها العاجز وعن مصالح الفئة العليا من البرجوازية المتمسكة به، إلى اعتماد القمع والعنف الدموي. فجرى قتل ثلاثة من عمّال معمل غندور المضربين قي سبيل حقوقهم، وقتل ثلاثة من مزارعي الدخان في مظاهرة في النبطية، وقمع الحركة الطلابية وغيرها، واغتيال القائد الشعبي والوطني معروف سعد في تظاهرة صيّادي الأسماك في صيدا، مُضافاً الى ذلك استخدام القوة العسكرية، ضد الوجود الفلسطيني، وتشجيع ومساعدة دور ميليشياوي ومشروع طائفي دموي، كان كيسينجر سكرتير الدولة الاميركية الذي زار لبنان عام 1974 قد شجّع على اعتماد هذا النهج الدموي والحربي في لبنان، تنفيذاً لمقتضيات الخطة الأميركية الصهيونية في المنطقة إعداداً لاتفاق كامب دايفيد مع أنور السادات (مصر). لذلك فإن الحرب الأهلية لم تكن وليدة الصدفة، أو نتيجة حادث بعينه. رغم أنها ذكرى أليمة، فإن ملفّاتها لم تزل بمعظمها مفتوحة، فلا عودة المهجرين اكتملت، ولا ملف المخطوفين انتهى، ولا القضية الاجتماعية حُلّت أو في طريق الحل، بل ازدادت تأزّماً. وكذلك الوضع الاقتصادي عامة، وفي مناطق "العودة" بخاصة.
والمصالحات التي جرت، بقيت وتبقى ذات طابع فوقي لأغراض ترتبط بالوضع السياسي. والنزف اللبناني بالهجرة إلى الخارج مستمرٌ. والأساسي في بقاء هذا الوضع الذي تتوالد في أحشائه الانقسامات العامودية والحروب الأهلية، هو هذا النظام الطائفي، الذي يسبب التباعد والحذر بين المجموعات اللبنانية، ويغطي الفاسدين وفسادهم، ويُستخدم لتشويه الوعي الوطني والاجتماعي، لذلك فإن "مقولة تنذكر وما تنعاد" التي يجري تكرارها سنويّاً، ليست كافية، وإن كانت تعبيراً عن كره الحرب. فالتمنيّات وحدها لا تبني سلماً أهليّاً راسخاً واستقراراً دائماً، بل يقتضي إلغاء الاسباب التي أدّت الى الحرب، الاجتماعية منها والوطنية، والتي ترتبط عضويّاً بنظام المحاصصة الطائفية... والمثل الصيني يقول "لا يكفي أن نسرع لإطفاء الحريق، بل يجب أن نمنع أسبابه".